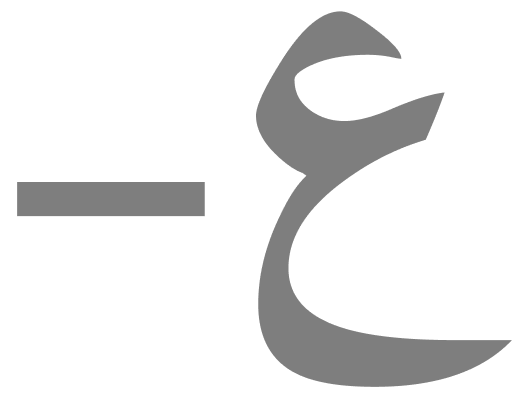الأمن القومي الأميركي بين الداخل والخارج
تعيش الولايات المتحدة حالياً فترة غير مسبوقة من الراحة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وهي مرحلة مؤقتة من السكينة تفترق عن مراحل تاريخية أخرى من الانخراط القوي والانشغال المكثف، وهو ما يسمح لنا بالابتعاد قليلًا عن الأحداث وتقييم الوضع الأميركي.
ومع أن الادعاء بأننا نمر بفترة من الهدوء قد يبدو غريباً، بالنظر إلى الحرب الأهلية في سوريا وبحث إيران الدؤوب عن السلاح النووي، وانفلات كوريا الشمالية، واستمرار الخطر الإرهابي، فضلًا عن صعود الصين وتهديدات التغير المناخي، إلا أنه رغم كل ذلك تعيش أميركا فعلًًا مرحلة من الهدوء في السياسة الخارجية، فعلى مدى الثلاثة قرون ونصف القرن السابقة تميزت العلاقات الدولية بتدافع القوى الكبرى المتنافسة فيما بينها، وسعيها لإلحاق الهزيمة بخصومها وإقامة نظام عالمي خاص بها.
هذا التدافع أنتج في القرن الماضي ثلاث مواجهات كبرى على الصعيد العالمي، هما حربان عالميتان مدمرتان وحرب باردة صعبة؛ واليوم ورغم استمرار التهديدات والأخطار، إلا أنها تنحصر في الإطار الإقليمي، أو تبقى محدودة في حجمها وقدرة تمددها، كما أنه لا أحد من تلك الأخطار ترقى إلى مستوى عالمي ولا تكتسي الطابع الآني والوجودي، لتبقى الولايات المتحدة القوة الأولى في العالم من دون خصم حقيقي، وهو أمر من المرجح استمراره في المستقبل المنظور ليظل السؤال الاستراتيجي المهم الذي يواجه أميركا هو كيف نمدد فترة الهدوء التي تتسم بها العلاقات الدولية بدلاً من إهدارها، وهذا يتطلب الامتناع عن الانخراط في الخارج وإعادة القوة الداخلية.
فنحن لم يعد بإمكاننا السعي إلى إعادة صياغة البلدان في الشرق الأوسط وجنوب آسيا كما حاولت ذلك أميركا بتكلفة باهظة وبنتائج متواضعة في العراق وأفغانستان.
وبدلاً من ذلك علينا إنعاش الاقتصاد الأميركي الذي من شأنه ليس فقط تحسين الظروف المعيشية للأميركيين، بل أيضاً توفير الموارد الضرورية لمنع القوى المنافسة من التفكير في خيار المواجهة، والتعامل معها في حال قررت ذلك.
والحقيقة أن إدارة أوباما اعتنقت جزءاً كبيراً من هذا الطرح في علاقاتها الخارجية، لا سيما فيما يتعلق بممارسة ضبط النفس في الشرق الأوسط الكبير، وإنْ كان الأمر لم يرق بعد إلى المستوى المطلوب في الشأن الداخلي لعدم القدرة على الدفع بالإصلاحات المهمة، لكن ومع ذلك تبقى الولايات المتحدة الأولى بين القوى العالمية الأخرى، هذا التفوق الأميركي يرجع في جزء منه إلى بعض نقاط القوة الذاتية، مثل الاستقرار السياسي، ووجود تركيبة سكانية سليمة والالتزام بحكم القانون، فضلًا عن الموارد الكبيرة في الطاقة والمعادن والمياه والأرض الزراعية، بالإضافة إلى الانفتاح الكبير على المهاجرين الذين ساهموا مساهمة كبيرة في الابتكار ودفع عجلة النمو.
هذا وتتوافر أميركا على مؤسسات تعليم عال راقية، وعلى نظام رأسمالي وقانون يسمح بالفرصة الثانية في حالة الفشل، ثم العلاقات الودية بين الدول المجاورة، بحيث تركز السياسة الخارجية على المناطق البعيدة خلافاً لأغلب الدول المنشغلة على الدوام بصراعات مع الجيران.
وبالنظر إلى هذه الإمكانات، لا أحد من القوى الدولية سواء الصين، أو روسيا، أو أوروبا، أو اليابان، أو الهند، مهيأ لتحدي التفوق الأميركي، فحصة الفرد الأميركي مثلًا من الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز بست مرات ما هو موجود في الصين، كما أن الولايات المتحدة تنفق على الدفاع أكثر من الدول العشر التالية مجتمعة.
ورغم ما يقال عن الصين، باعتبارها القوى الأكثر قدرة على تحدي أميركا، فإنها تعاني تباطؤ النمو الاقتصادي، والفساد المتفشي، بالإضافة إلى التآكل البيئي، وشيخوخة السكان ونظام سياسي فوقي، لذا لا تسعى الصين وبقية القوى الدولية إلى تغيير النظام العالمي القائم بقدر ما تحاول الانضمام إليه.
لكن هذا الوضع يجب ألا يدعو إلى المبالغة في الاطمئنان، ذلك أن التفوق لا يرخص القيام بكل شيء، لا سيما وأن مرحلة الهدوء، التي تمر بها أميركا تبقى مؤقتة، وهي بمثابة ابتعاد عن التاريخ وليس نهايته، ما يسمح بتغيير الاهتمام وليس الانسحاب من العالم، لذا يتعين التركيز خارجياً على المناطق التي تبقى فيها المصالح الأميركية واضحة، وحيث وسائل التأثير، مثل الجيش والمساعدات والتجارة والدبلوماسية يمكنها تحقيق الهدف، وهو ما يعني الحد من الحروب الاختيارية ووقف محاولات تغيير المجتمعات، مثل غزو العراق في 2003 والزيادة في عدد القوات بأفغانستان في 2009، كما يعني عدم التدخل العسكري المباشر في سوريا، وعندما يتعلق الأمر بإيران، فيجب تغليب الدبلوماسية والعقوبات والبحث عن بدائل أخرى لإقناعها بعدم اجتياز العتبة النووية، والأهم من ذلك علينا مضاعفة الجهود للحفاظ على الاستقرار في آسيا والمحيط الهادي، حيث تتزايد مخاطر الاحتكاك والصراع بين القوى المتنافسة، وحيث الوسائل العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية الأميركية مؤهلة لمنع حصول ذلك، أما داخلياً فعلينا استعادة أسس القوة الأميركية، دون أن يعني ذلك المبالغة في الإنفاق، حيث لا توجد بالضرورة علاقة جدلية بين الاستثمار والنتائج.
فالولايات المتحدة تنفق مرتين أكثر على الفرد في مجال الصحة من باقي الدول الصناعية دون تحقيق النتائج المرجوة، كما ننفق أكثر من غيرنا في الدول المتقدمة على التعليم بنتائج غير واضحة. وبدلاً من الإكثار في الإنفاق، يمكن استقطاب أفضل المدرسين وإعطائهم الحوافز للنجاح، وتمكين الآباء والطلبة لاختيار أفضل المدارس.
كما يمكننا بخطوات حكومية بسيطة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعادة ترميم البنية التحتية المتداعية، وإعادة صياغة قانون الهجرة ليمنح فرص أكبر لأصحاب الشواهد والمهارات، والأهم من ذلك تقليص أنظمة الاستحقاقات على المدى البعيد لخفض نسبتها من الناتج المحلي الإجمالي، هذه الخطوات وغيرها من شأنها إعادة الازدهار إلى أميركا دون أن يعني أنها وصفة نحو الانعزال، بل هي استراتيجية كبرى للولايات المتحدة تتعامل مع الأمن القومي كمجال للسياسة الخارجية، كما الداخلية.
ريتشارد هاس
رئيس سابق لمجلس"العلاقات الخارجية الأميركي"
ينشر بترتيب خاص مع خدمة "نيويورك تايمز"