

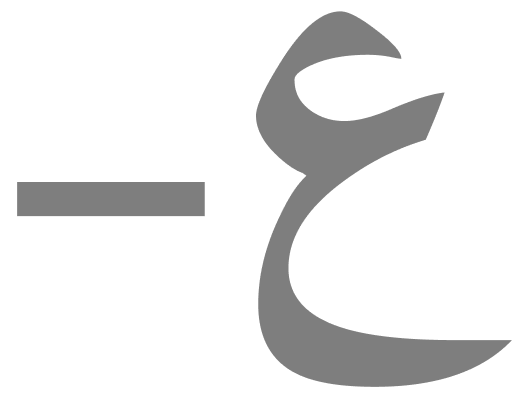
عبدالدّائم السلاّمي
«من يكتب حكايتَه يَرِثْ أرضَ الكلام، ويملك المعنى تماماً!»
«محمود درويش»
ليس باستطاعةِ الإنسان أنْ يُوجد خارجَ حكايته، ولا يمكن له أن يكون بطلاً في حكاية غيره، لأن حكايةَ كل واحد منّا إنّما هي حياتُه، وهي الشيءُ الشخصيُّ الذي يُميّزه، كالبصمة، عن باقي مجموعته الاجتماعيّة، وهي منه بمحَلّ مجموعِ كيانِه الجسديّ والنفسيّ والاجتماعيّ والثقافيّ، وإذْ تُروى الحكايةُ الشخصيّةُ تصيرُ أكبرَ من صاحبها تأثيراً في الأرضِ وأثراً، وذلك من جهة كونها تسبقه إلى الدّنيا وقد تَبْقى فيها بعدَه فتكون أشدَّ ِصلةً به وأكثرَ دَلالةً عليه من نسلِه، ذلك أن الإنسانَ يعيش في جسده مؤقتاً، بينما يظلّ يعيش في حكايته أبداً. وما يُعزِّزُ وجاهةَ ما مرّ معنا هو وقوعُه في حيِّزِ مفهومِ «الهُوية السردية» الذي اقترحه بول ريكور في بعض ما كتبَ وشرحَه بقوله إنّ فهمَ الذّات ليس إلاّ عمليةَ تأويلها، وإنّ أفضلَ طريق إلى تأويل الذّات إنما هي طريقُ السردَّ، وستقودنا طريق السّرد هذه إلى كتاب «لا تستسلم.. خلاصة تجاربي» لنتعرّف فيه على تفاصيلَ السيرةِ الذاتيةِ للأكاديمي والكاتب الإماراتي جمال سند السويدي، من حيث ما هي حكايةٌ ذاتُ اشتغالٍ أدبي وقِيَمي، تنهض مادّتهاُ الخبريّةُ على سيرته الشخصية وهو يُواجِه بجُرأة ظافرةٍ عَدُوَّيْن متمكِّنين: عَدُوَّ الوطن وعَدُوَّ الجسدِ.
روايةُ السِّيرةِ
تُحيلُ قراءةُ هذا الكتابِ على حقيقةِ أنّ بناءَه الحكائيَّ قد نهضَ على دعامتيْن: دعامة التَّدْبيرِ الفنيّ لمحتواه الخَبَريِّ، ودعامة انفتاح الذّاتيِّ فيه على أُفُقه الوطنيّ، وقد تعاضدت هاتان الدّعامتان لتجعلا مَتْنَ الكتاب يرقى إلى مَرْقَى من الأدبيّةِ عالٍ، ولتُؤكّدا في الآن نفسه صدقيّةَ مرجعه الواقعيّ وفاعليتَه القِيَميةَ والوطنيةَ، ذلك أنّ هذه السيرة إنّما هي «قصّة نجاح قامت على الجدّ والاجتهاد والإخلاص للوطن ولقيادته».
لقد انصبّ التدبيرُ الفنيُّ لمتنِ كتاب جمال سند السويدي على تنزيله منزلةَ السِّيرة الذاتية، وهو ما أشار إليه الكاتب بقوله: «فإنّ الإقدام على نوعٍ جديدٍ من الكتابة يقوم على الذّات يحتاج مني إلى... أنْ أُطلقَ العنانَ لتلك الذّات التي كانت مناهج البحث العلمي وقواعده تقتضي مني تحييدها، أو إلقاء ستار عليها، ومنعها من الظهور في كتاباتي». يُضاف إلى ذلك ذِكرُ السويديّ عبارةَ «السيرة الذّاتية» في مفتَتح كتابه حين قال: «لم يكن لهذه السيرة الذاتية أن تظهر إلى النّور لولا تجربتي مع مرض السرطان»، هذا ناهيك عن نشره صوراً له فرديّةً وأخرى مع شخصيات وطنية وأجنبية معروفة في أمكنة عديدة وخلال مناسبات معلومة تمّت الإشارة إليها في المَتْنِ النَصِّيِّ، وبهذا يكون الكاتبُ قد حقّق الميثاق السِّيرَذاتيّ ونبّه إلى أنّ عملَه إنّما هو خُلاصةُ معيشٍ شخصيٍّ غامر فيه بفكره وبجسده إلى أبعدِ حُدود المغامرة، ومن ثمّة فإنّ قراءته لا تبلغ غايةَ دلالاتها إلاّ متى راعى فيها القارئُ الأشراطَ الفنيّةَ للسيرة الذّاتية نفسِها من جهة كونها نوعاً سرديًّا يذهب نقّادُ الأدب في تحديدِ سماتها إلى قولهم إنها فنٌّ اعترافيٌّ، يظهر فيها التطوّرُ النفسي والاجتماعي والسياسيّ لصاحبها، وتنكشفُ ضمنها دراما حياته، أيْ: مَشْهَدِيَّاتُ صراعِه مع مفردات واقعه، سواء أَكانت عراقيلَ أم مُحفِّزاتٍ.
ومن المظاهر الأخرى لحُسنِ تدبيرِ الكاتب سيرتَه الذاتيةَ توزيعُه لها على فصول خمسة هي: «النشأة»، و«الطريق إلى المستقبل»، و«الحياة المهنية»، و«معركة السرطان»، و«السفر والجوائز والتكريمات»، وهو توزيع راعى فيه المسارَ الخطّي لتطوّر الأحداث، وإنْ كنّا لا نعدم -في حالات قليلة- وجودَ ارتجاعات واستباقات أَمْلاها نزوعُ المحكيِّ السِّيرَذاتيِّ إلى التكوُّن الأدبيِّ، وصورةُ ذلك انْبِناءُ هذا المَحْكيِّ وَفْقَ حركةٍ سرديّةٍ ذات خمسِ مراحل هي التوازن الأولي، والاضطراب، واختلال التوازن، والاضطراب المعاكس، والتوازن النهائي، ومتى راعينا الترتيبَ الذي اقترحه تودوروف لهذه المراحل قلنا إنّ كلّ واحدة منها إنّما هي تُمثّل حيِّزاً تتحرّك فيه حكايةُ فصلٍ من الفصول المذكورة، وذلك ضمن تعالُقٍ في الأحداث وتضافُرٍ في الدّلالات هما من الكتاب سببُ تَشكُّلِ وَحْدتِه النصيّةِ، فإذا هو أثرٌ فنيٌّ محمولٌ في سيرةٍ ذاتيةٍ.
ولا شكّ في أنّ تحمّل جمال سند السويدي أعباءَ كتابة سيرته الذاتيّة لم يكن من أجل شهرة أو إضاعة وقتٍ، وإنما كانت الغاية منه هي «اسْتِزْراع النَّجاح»، عبر إفادة مجتمع القرّاء بخُلاصات تجربته الحياتية بكلّ ما فيها من إصرار على الانتصار إلى الحياة والوطن وقِيَمِ الخير فيهما. ذلك أنّه زرع في نسيج نصّه جُمَلاً كثيرةً مشحونةً بإيقاعٍ حِكَميٍّ وصدًى فلسفيّ، وحَمَّلها مسؤوليةَ أن تكون رسولَه إلى شَحْذِ هِمَمِ القرّاءِ على تمجيدِ الحياة عبر حكمةٍ أو نصيحةٍ أو طُرفةٍ يزرعها هنا أو هناك على غرار قوله: «إنّ إنجازات الشخص وأعماله أصدقُ إنباءً من الكتب التي تتحدّث عنه، وإن المشروعات الناجحة أبلغُ من الفصول الناجحة في الأسفار والمؤلَّفات»، أو قوله: «بقدر ما تتجدّد الحياة كلّ لحظة، يجب أن نتجدّد نحن لنُواكب وتيرتَها السريعةَ»، وكذلك قوله: «كيف لطالب يدرس الهندسة، أو الاقتصاد، أو الحاسب، أن تتمحور اهتماماته الكبرى حول قضايا كعذاب القبر، وآداب الذّهاب إلى الخلاء في زمن ليس فيه خلاء بل حمّامات تُنافس غرف الصالون في الفخامة». والبيّن أنّ تنوُّعَ طرائقِ تنزيلِ السويديّ سيرتَه الذاتيةَ منازلَ فنيّة هو في تقديرنا ما منحَها وحدتَها المعنويّةَ، بل وأَظْهرَ فيها بُعْدَها الرِّوائيَّ، وذلك من جهة «أنّ كلَّ سيرة إنّما هي روايةٌ تأبَى أن تُعلِن عن كونها روايةً»، بل إنّنا لَنَرَى أنّ وراء ذاك النزوعِ الأدبيِّ تُوجد رغبةُ السِّيرةِ الذاتيةِ نفسِها في التَّصَيُّرِ سَرْدِيّةً وطنيّةً جديرةً بأن تُرْوَى وأنْ تتوسَّعَ دوائرُ تأثيرِها في فضاءِ المجتمع القرائيّ الإماراتي والعربي والعالمي على حَدِّ ما سنُوضّحه في العنصر الموالي.
إنّي أرْوي واجِباً
ما يغلب على أمرِ السِّيرةِ الذاتيّةِ ويُخيفُ كلَّ مَن يرغبُ في كتابتِها ليس إثباتُه صِدْقِيةَ ما يقول فيها فحَسْبُ، وإنما هو أيضاً حِرصُه على تَحْصِينها من أن تتسرَّبَ إليها سيرةٌ أو سِيَرٌ غَيْرِيّةٌ يمكن لها أن تُلغي سيرتَه هو نفسِه، ففي السِّيرة الذّاتية لا يُواجِه الكاتبُ تاريخَه، إنه يُواجه بطولةَ الآخرين في تاريخه، بل هو يتمنى، وإنْ خُفْيةً، لو أنّ هؤلاء الآخرين لم يُوجَدوا في حياته أبداً، غير أنّ الغالبَ على المَحْكِيِّ السِّيرَذاتيّ لجمال سند السويدي هو تقاسُمُه دورَ البطولة فيه مع قادة بلاده، ومع شخصياتها الفاعلة في تدبير الشأن العامِّ، لأنه يستشعر بأن كتابةَ سيرته هي ضرورة شخصية ووطنية معاً، وهو أمرٌ بيِّنٌ في قوله: «لقد أحْسستُ بأنّني أروي واجباً»، وضمن هذه الضرورة تماهت مراحلُ حياة الكاتب بمراحل مَسيرة الوطنِ الحضاريّة من حيثُ مغالبةُ ضاغطاتِ الواقع بفضل قوّة عزيمته التي تجلّت في رفضه «الاستسلامَ في اللحظات التي كان أيّ انهيار للمعنويّات فيها يعني موتاً مؤكَّداً»، وكذلك من حيث التعويلُ على الذّات في النهوض الثقافي والاجتماعي والسياسي، فإذا بقارئ كتاب «لا تستسلم.. خلاصة تجاربي» يتنقّل فيه بين سِيرتيْن: سيرةِ المُواطِن وسيرةِ الوطن، وهذا ما نراه قد حقّق بلاغةَ هذا الكتاب وأَصَّلَه في أُفُقٍ وطنيٍّ هو عند جمال سند السويدي حاضنةٌ ناعمةٌ لكلّ قِيَمِ التَّسامُح والخير والاجتهاد والإبداع والتثمين.
تضمّنت سيرة السويدي الذّاتية فترات صعبة مليئة بالعقبات وأخرى مليئة بالانتصارات، فأمّا عناوين الفترات الصعبة فمنها رفض قبوله بقائمة المبتعثين للدراسة بالخارج، وعدم تعيينه أستاذاً مشاركاً بالجامعة بعد عودته من الكويت، وذلك بسبب سيطرة جماعة الإخوان على مفاصل التربية في الإمارات، ثم دخوله في مواجهة مع الأساتذة المنتمين أو المتعاطفين مع تلك الجماعة، إضافة إلى إصابته بمرض السرطان. وأمّا عناوين فترات المجد فمنها زواجُه، وولادةُ ابنه خالد، وحصولُه على الدكتوراه، وتأسيسُه لمركز الإمارات للبحوث بدعم من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، وانقطاعُه عن التدخين، وتأليفُه الكتب، ونيلُه الجوائز والتكريمات. وقد لخّص الكاتب ذلك بقوله: «فالطفل الذي أبصر النور في عام 1959 لأسرة متواضعة، ووالدين أميين لم يكن ليتوقع أنه في سنوات حياته المقبلة سيصبح واحداً من نخبة الفكر في بلده، وأن العسر سينقلب بفضل الله رخاء ويسراً، وأنه سيقود العمل في مؤسسات كبيرة وناجحة، وسيقف على منصات التكريم في بلده وفي أهم بلدان العالم، وسيحصل على كثير من التقدير المادي والمعنوي، ولو قيل لهذا الطفل وقتها إن مقابلة زعماء العالم وقادته ستصبح أمراً روتينياً ومعتاداً بالنسبة إليه حين يكبر، لظن ذلك إفراطاً في الخيال، أو ضرباً من المستحيل».
