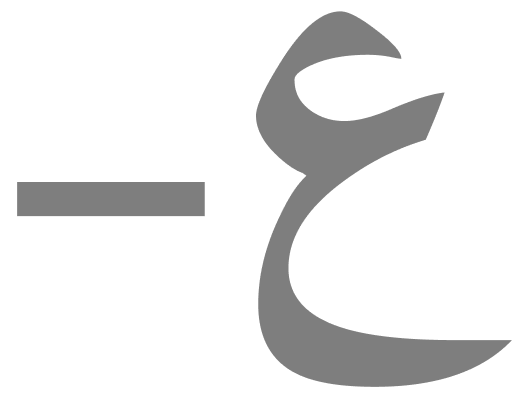بادئ ذي بدء لا بد من الإقرار بأن المسرح في حاجة إلى الأطفال، خاصة في البلاد العربية، حتى يتطور ويخلق لنفسه قاعدة واسعة من المحترفين وأرضية صلبة من المتابعين، إلا أن ذلك لن يتحقق - في تقديرنا - إلا من خلال ضبط استراتيجية على المدى البعيد تأخذ بعين الاعتبار في المرحلة الأولى مكونات العملية المسرحية، لا سيما تلك المرتبطة منها بالاختيارات الجمالية، ومنها على وجه الخصوص الكتابة بما تفرزه من مضامين على أن يتم الاهتمام في مراحل لاحقة بالبحث عن آليات التوزيع والترويج.
بناء على ذلك، فإن الاهتمام بالكتابة لمسرح الطفل لا يمكن أن ينطلق في الوضع الراهن إلا من الرصيد الذي بدأ بالتشكل لدى العاملين في هذا الميدان، منذ أن تم اعتبار مسرح الطفل ممارسة تنتمي بحق إلى المسرح ولا فرق بينها وبين الأنواع المسرحية الأخرى. إن ذلك الرصيد الذي تكوّن منذ مطلع القرن الماضي يعتبر محدوداً جدّاً مقارنة بالكمّ الهائل من النصوص المسرحية الموجهة للكبار وهو بتلك الصفة لا يسمح للمطالع المتعجّل أو للباحث المتأنّي بالخروج بنتائج نهائية إلا أنه، رغم محدوديته، تلك، قد يعين المهتم بمسرح الطفل على فهم التوجهات الكبرى التي قادت مسيرة الكتابة فيه سواء من حيث مصادر الإلهام التي قامت عليها أو من حيث التقنيات المعتمدة.
لقد توصلنا في بحثنا عن مسرح العرائس في تونس، ومن خلال اشتغالنا على مدونته النصية، إلى أن المصادر التي استلهم منها المؤلفون نصوصهم تتمثل في:
? الحكايات الشعبية العربية المحلية منها والعالمية باعتبارها شكلاً تقليدياً يحتوي على ذاكرة شعب ما.
? نصوص أدبية سردية عربية أو أجنبية وقع اقتباسها وتحويلها إلى نصوص مسرحية.
ولقد لاحظنا أن هُناك تنوعاً في مصادر الإلهام يقوم دليلاً على تواصل مع منزع عالمي في الكتابة لهذه الشرائح يعتمد المصادر المذكورة ولا يتجاوزها إلا قليلاً، وحتى إذا حاول أن يكون إبداعياً فإنه في الغالب لا يبتعد عن المناخات العجائبية التي يوفرها الموروث الحكائي الشعبي.
إن المواضيع التي يتناولها النص المسرحي الموجه إلى الطفل تقوم دليلاً على استمرار حضور السرديات غير العقلانية في عصر تطغى عليه قيم العلم والمنطق، بالرغم من أن الدعوة إلى إقامة عالم عجائبي بديل يتمثل في الحقائق العلمية والاكتشافات الحديثة والذي تبنته المربية الكونتيسة دي جنليس (1746 - 1830) بدأ بالظهور منذ نهاية القرن الثامن عشر، إلا أنه لم يتمكن من أن يأخذ مكانة مهمة ويتحول من ثمة إلى مصدر للإلهام والكتابة.. بل إنّ تنامي الإقبال على العجائبي والغرائبي يؤكّد استمرار الحاجة إليه لصياغة نصوص مسرحية - إن بدت بسيطة وساذجة لدى البعض- فإنها بشهادة علماء نفس الطفل قادرة أكثر من غيرها على تناول قضايا الوجود بطريقة مقتضبة ودقيقة، تسمح للطفل بمواجهة القضايا في تجلياتها الأساسية دون تعقيد كبير. أما من حيث التقنيات فإن الخصوصيات المرتبطة بالكتابة لمسرح الأطفال تكمن في كونها كتابة حديثة بالأساس؛ لا تفرض تقسيم النصوص إلى فصول ومشاهد بصفة جامدة؛ إذ يكفي أن ينفتح النص المسرحي على خيال له علاقة بالفرجة الجماعية، يدعو باستمرار المتفرج إلى الإضافة من خلال تركيبه الذكي لمفردات العرض، وبذلك تتحقق متعة الفرجة. فالكتابة بهذه الصفة ليست هي وحدها المسؤولة عما يقدم إلى الطفل.
أما عن الطرائق الأكثر انتشاراً في الممارسات الحديثة؛ فهي تلك التي لا تفصل بين الممارسة الميدانية وفعل الكتابة ذاته، فمنذ ثمانينات القرن الماضي خرجت النصوص من رحم الممارسة؛ إذ تعهّد المخرجون باقتباس وتطويع عدد من النصوص السردية لتظهر في نهاية المطاف ضمن عرض قائم بذاته لا يمثل النص فيه سوى جزء قد يكبر أو يصغر حسب نوعية المقترح الجمالي، وحسب السن التي يتوجه إليها العرض.. إن ما يمكن استنتاجه من مجموع طرائق الكتابة لمسرح الطفل أنها جميعاً لم تعد تسعى لإبلاغ شيء إلى الملتقي بقدر سعيها إلى الاشتراك معه في مشروع جمالي؛ لذلك نراها تولي جانباً هاماً للصورة والصوت والحركة والايقاع وكل العلامات المرئية حتى تشد الانتباه، وهو ما يبرر استنادها الضروري إلى عقلية العرض وخلفياته الفكرية الجمالية. إن الانطلاق من العرض هو الذي كان وراء الفكرة القائلة بانتهاء زمن المواضيع الخاصة بالأطفال؛ إذ بالإمكان تقديم النصوص المسرحية الكبرى لفائدتهم، وقياساً على ذلك لا نجب أن نستغرب من وجود هاملت أو عطيل أو أوديب الملك في قائمة الأعمال الموجهة لجماهير الصغار، شريطة أن تكون معالجتها قائمة على الأحداث ذات البناء الدرامي السليم، وأن لا يتجاوز العرض ساعة إلا الربع في أقصى حالاته، وأن لا يلتزم التزاماً صارماً بالنهايات السعيدة. ذلك أن كتابة تترك الباب مفتوحاً ليتخيل كل مشاهد النهاية التي يرتئيها تعتبر طريقة جيدة لدى علماء نفس الطفل ومن بينهم على وجه الخصوص فرنسواز دولتو ومود مانوني.
لقد حاول عديد الباحثين رصد الأعمال المسرحية الموجهة لجمهور الشباب بصفة عامة، واقترحوا تصنيفات عديدة لعلّ الأقرب منها إلى واقع الممارسة هو التصنيف الذي اقترحه الباحث البلجيكي المختص في مسرح الأطفال “روجي دلديم” والذي يقسم فيه أنواع الإنتاج المسرحي الموجه إلى الأطفال إلى خمسة أصناف اعتماداً على الموضوع الذي يقترحه كل نوع منها وهي:
? المسرح التعليمي: وهو يسعى إلى تثقيف الأطفال وتزويدهم بمعارف يواكبون من خلالها ما يحدث حولهم في جميع نواحي المعرفة، وهو لهذا الغرض يركّز على المضامين أكثر من اهتمامه بالجوانب الفنية لكنه رغم ذلك يساهم في مؤالفة الأطفال مع الظاهرة المسرحية.
? المسرح الوعظي: وتتمثل مهمته في تهيئة الطفل لمواجهة القضايا التي ستعترضه في الحياة العامة وإعداده ليكون مواطناً صالحاً حسب الأخلاق السائدة في المجتمع. ويعمد هذا النوع إلى إبراز شخصيات نموذجية في مجالها حتى يتبين المتقبل من خلال أفعالها الحدود الفاصلة بين الخير والشر وحتى يتماهى معها وينسج على منوالها لما يصبح يافعاً أو كهلاً.
? المسرح السياسي: إنه مسرح ملتزم يسعى إلى تجاوز البطل بالمفهوم الكلاسيكي ونزع القدسية عنه لإظهاره شخصية ذات محاسن ومساوئ بعيدة كل البعد عن المثالية، وهو مسرح ذو وظيفة اجتماعية يهتم بكل القضايا المعاصرة، خاصة منها تلك المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية والتمييز العنصري والطبقات المضطهدة والصراعات والحروب، وهو يعمل على تزويد المتفرج بفكر نقدي يتجنب ردود الفعل العاطفية.
? المسرح الشعري: وهو نقيض المسرح السياسي لأنه يسعى إلى التأثير على الطفل بواسطة مقترحه الجمالي المبهر معتمداً على الرمزية حيناً وعلى الواقعية حيناً آخر، وهو يسعى إلى تنمية الخيال وتحسيس المشاهد بجمال الحياة ورونقها.
? المسرح الترفيهي: يعتمد أساساً على إقامة علاقة تفاعلية مع المتلقي لتمرير المعلومة، وغايته تأمين الارتياح في نفوس الأطفال من خلال ما يقترحه من عروض تبدو بمثابة الألعاب التي يشارك فيها الأطفال ليصبحوا فاعلين، وذلك دون التضحية بمقومات العمل المسرحي.
هذا التصنيف يبدو منهجياً لأنه لا حدود فاصلة في الواقع بين الأنواع المذكورة فقد تتداخل في نفس العرض بعضاً من العناصر المذكورة هنا وهناك غير أن القيمة الفنية هي الفيصل في نهاية المطاف، وهي التي يعوّل عليها للحكم على انتماء عرض ما إلى مسرح الأطفال.
إن تناول مسألة الكتابة على حده لا يجب أن يحجب عن أعيننا المسائل الأخرى المرتبطة بمسرح الأطفال وفي صدارتها التكوين والتكوين المستمر لكل العاملين في هذا القطاع؛ إذ لا يمكن الحديث عن كتابة بمعزل عن الممارسة.. فلا يجب أن نتصور المؤلف المسرحي المختص بعيداً عن الخشبة وعن طرائق اللعب وعن ردود فعل الجمهور، وهو لذلك يجب أن يكون بصفة الدراماتورج بالمفهوم الألماني للمصطلح؛ أي ذلك الشخص الساهر على انتقاء المواضيع وحبكها والمسؤول المستشار لدى طاقم العمل، من مخرج العمل إلى الممثلين وكل المنفذين، بصفته خبيراً مطلعاً على الرصيد المخصص لتلك الشرائح العمرية وعارفاً بالاقتباس والترجمة والتأليف.
إن وجوده الدراماتورج يجعل من العمل الموجه إلى الأطفال عملاً جماعياً بالضرورة يقوم على عقلية المخبَر أو الورشة الدائمة المتجددة بتجدد المواضيع والاهتمامات والمواكبة لكل المتغيرات. وإن كان لابد من أن تتحول خصوصية هذا المجال إلى اختصاص ضيق فإن طريقة العمل المشار إليها هي أول خطوة نحو الاختصاص الدقيق، سيعقبها لا محالة تطوير لآليات العمل حسب ظروف كل مجتمع وملابساته، شريطة عدم التضحية بالقواعد الأصلية للفن المسرحي الذي يبقى في المحصلة النهائية معلّماً بطبعه لا بما يطرحه من مواضيع.
* مدير المعهد العالي للفن المسرحي
** قدمت هذه الورقة في ملتقى مسرح الطفل العربي الذي نظمته مجموعة مسارح الشارقة