

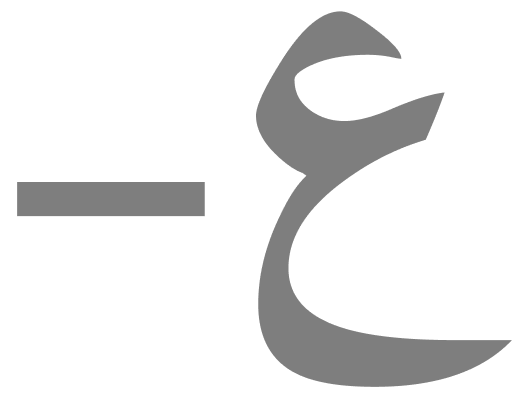
أبوظبي (الاتحاد)
يصف مبارك بن لندن «الاسم العربي»، أو ويلفرد ثيسجر «الاسم البريطاني» 1910 - 2003، رحلته التي قام بها رفقة اثنين من الإماراتيين من قبيلة الرواشد، هما سالم بن كبينة، وسالم بن غبيشة، إلى الربع الخالي، ومن صلالة في سلطنة عمان إلى أبوظبي، مروراً بواحة ليوا ومدينة العين عام 1948 ولمسافة تقدر بنحو 1500 كلم، بالجمال، ومشياً على الأقدام، بأنها واحدة من أجمل وأقسى رحلاته، كونها سجلت أشهر عبور لصحراء واسعة شاسعة لم تطأها قدم أوروبي من قبل على ظهور الجمال.
ويورد ثيسجر الكثير من القصص والحكايات عن رحلته هذه في كتابه «الرمال العربية»، مثل كرم البدوي الأسطوري، وصبره الشديد خلال اجتيازه الصحراء والكثبان الرملية، وقصص وأحاديث عن قسوة عبور الصحارى والطرق، والتحديات التي واجهها ورفيقاه في موضوعة المواصلات والسير والتنقل.
وتحدث الرحالة الإنجليزي مطولاً عن لقائه بالأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، وكيف أعاره ناقته «غزالة»، وهي أشهر وأجمل ناقة عرفت في ذلك الوقت، بالجزيرة العربية.
وتقودنا هذه الحكايات إلى الحديث عن الطرق والمواصلات القديمة التي كان عمادها سفينة الصحراء، وربما أيضاً يلزم أن نفتتح حديثنا حول «المقيظ»، وهي إحدى الرحلات التي ابتدعها الإماراتي ليواجه حرارة الصحراء عبر التنقل من مناطق الساحل، التي تشتد حرارتها ورطوبتها صيفاً، إلى المناطق المعروفة بالمقايظ، ومنها «البراحات»، و«الواحات»، و«المحاضر»، التي غالباً ما تمتاز باعتدال الطقس.
وتعتبر قوافل الجمال الوسيلة الرئيسة لرحلات الحضّار إلى المقائظ، والتي تستخدم لعبور الصحراء والوديان والجبال، كما تستخدم السفن الخشبية الصغيرة والكبيرة وسائل للنقل إلى المناطق البعيدة، إضافة إلى استخدام الدواب، مثل الحمير، كما تستخدم القوارب الخشبية الصغيرة المعروفة باسم «الشواحيف» للتنقل إلى المناطق القريبة.
أما البراحات، فاشتهرت كمقائظ في بعض المدن الساحلية منها أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، وتمتاز بمساحات واسعة من أشجار النخيل وآبار المياه العذبة ورمالها البيضاء، ويقصدها الأهالي لقضاء فترة الصيف، ويطلق على هذه المناطق أسماء عدة، مثل البراحة أو النخل، وتتسم بالهواء المعتدل نتيجة بعدها عن الساحل.
وساهمت رحلات المقيظ، بشكل لافت في تنشيط الحالة الاقتصادية لأهل مدينة العين على سبيل المثال، فقد كانت القوافل من الجمال تقوم بنقل كميات هائلة من الليمون، وإيصالها إلى أسواق أبوظبي ودبي في رحلات تستغرق 14 يوماً ذهاباً وإياباً بين العين ودبي، و12 يوماً بين العين وأبوظبي، ومن هناك تعود القوافل محملة باحتياجات الأهالي من المؤن المختلفة. كما أن كميات كبيرة أخرى من منتجات النخيل تتحول إلى تمور تحفظ نسبة كبيرة منها للاستهلاك الخاص في بقية أشهر السنة وحتى الصيف التالي، كانت القوافل تحملها عبر طرق صعبة وقاسية.
كان الانتقال من مكان إلى آخر في الإمارات قديماً يمثل رحلة من المرارة لأسباب مختلفة، من أهمها صعوبة الطرق، سواء كانت صحراوية رملية أو صخرية قاسية، وكذلك عدم وجود وسائل للمواصلات والتنقل سوى الإبل والدواب وفي النادر الخيول؛ لذا كان الانتقال من مكان لآخر يستغرق الكثير من الوقت والجهد.
ويذكر السير برنارد بوروز، وهو أول مقيم سياسي بريطاني في الخليج، أن زوار أبوظبي اليوم ستصيبهم الدهشة حين يعرفون أن الطرق المؤدية إلى المدينة في أيامه كانت خطرة تماماً بسبب المناطق الموحلة قرب الساحل، والتي كانت السيارات تغرز فيها بسهولة، مشيراً إلى أن القيادة في الصحراء كانت أسهل من القيادة في المدينة بسبب صلابة الأرض في الصحراء، بينما كان الرمل ناعماً وعميقاً في جزيرة أبوظبي، وكان يتعين تجهيز جميع السيارات بإطارات بالون خاصة بالرمال لتتمكن من السير، وكان معظم السائقين يحملون ألواحاً معدنية، وعندما تغرز السيارة كانت توضع الألواح المعدنية تحت إطارات السيارة، وتستخدم المجارف لإزاحة الرمال من حولها.
معبر المقطع
ولأنه لم تكن هناك طرق في جزيرة أبوظبي حتى 1961، كان هناك معبر مرتفع عند المقطع عام 1952، وكان هذا المعبر مصنوعاً من الحجر والطين، وكان مرتفعاً بمقدار قدمين تقريباً فوق سطح الماء حتى تتمكن السيارات والجمال من المرور، وقبل إنشاء هذا المعبر كان على قوافل الجمال أن تنتظر ساعات حتى يتراجع مد البحر، ورغم ما كان يمثله عبور القناة الفاصلة بين البر الرئيس وجزيرة أبوظبي من صعوبة، كانت رادعة للمتسللين.
ويعد «برج المقطع»، أحد أقدم المباني في أبوظبي، بُني فوق جسر ضحل منخفض المد يربط بين جزيرة أبوظبي والبر الرئيس، ويمثّل البرج الذي تم بناؤه في أواخر القرن الثامن عشر أثناء بناء قصر الحصن أحد النماذج القليلة للأبراج الساحلية الدفاعية المبنية من حجر المرجان وأحجار الشواطئ، ولا يزال يمثل البوابة المادية والرمزية لجزيرة أبوظبي، إلى جانب العناصر البارزة في المنطقة، مثل: طريق المقطع ودائرة الجمارك وجسر المقطع وجسر الشيخ زايد.
وكان البرج حتى فترة الخمسينيات من القرن الماضي علامة للمسافرين يستدلون بها على وصولهم إلى جزيرة أبوظبي وخروجهم من تلك الصحراء القاحلة.
ومع بعد المسافة من المدينة إلى قصري الحصن والبطين الواقعين في منطقة بعيدة من الجزيرة، كان برج المقطع بمثابة مكان يستريح فيه المسافرون قبل عبور المسطحات المالحة في جزيرة أبوظبي على الطريق الممتد إلى المدينة، ومع إنشاء جسر المقطع، بات البرج من الأبنية القديمة المهجورة، إلا أنه رغم ذلك يظل رمزاً يمثل الأهمية التاريخية لهذه المنطقة، التي تم بناؤه فيها لاستخدامه كجهاز للمراقبة لرصد أي غارات للصوص والأعداء في تلك الأوقات، وإبلاغ سكان الإمارة من أجل الاستعداد لمواجهة أي أخطار قد تهددهم، خاصة أن عمليات المد والجزر لعبت دوراً رئيساً في فصل جزيرة أبوظبي عن البر الرئيس للإمارة، ما أدى إلى وجود مسافة مائية كبيرة بين اليابسة واليابسة، وكان لا بد من وجود نقطة إنذار أو مراقبة تنبه السكان إلى وجود خطر يتربص بهم من ناحية البر، لذا أُنشئ هذا الحصن ليؤدي هذه المهمة النبيلة.
وتشير الدراسات إلى أن الطرق أمام القوافل الإماراتية قبل اكتشاف النفط لم تكن معبّدة، بل كانت تشق مسالكها بين شعاب البوادي دون بوصلة، وسط الرمال للوصول إلى هدفها، وكان الأهالي يستعينون ببوصلاتهم الغريزية، وما تختزنه ذاكرتهم من خطوط الطرق التي كانت ترسمها الرياح والعواصف التي غالباً ما تغيّر من أشكالها، كثبان رملية تأخذ شكل أقدام الجمال التي تعلمت الصبر في سبر أغوار الصحراء، فيما امتاز أهل البادية بالمعرفة الجيدة بالطرقات والدروب والمسارات الصحراوية، فقد فرضت عليهم ظروف الحياة أن يتقنوا هذا الأمر من أجل البحث عن الماء والطعام لهم ولماشيتهم.
ويقول الباحث التراثي والمؤرخ الإماراتي ناصر العبودي: «إن قصة هذه الدروب والمسارات ليست قصة انتقال من مكان إلى مكان فحسب، وإنما تختصر بتفاصيلها علاقة القبائل العربية الوثيقة مع المكان والزمان وتشكل بالنسبة لهم معالم تنبض بالحياة وسط الصحراء الموحشة وطرق النجاة الوحيدة من حياة قاسية ووسيلة لسد رمق الجوع وشراء الملابس والمؤن، فقد كان الطريق الدولي من أبوظبي حتى السلع على حدود دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية عبارة عن درب صحراوي تسلكه القوافل والمسافرون والقادمون من أبوظبي، تتحرك القوافل، ومن في حكمها من الشارقة إلى الذيد، ويمرون على مناطق الزبير وطوي راشد الغربية وطوي راشد الشرقية وطوي بن حليس مشياً على الأقدام والبعض يستعين بالإبل، أما المتجه من الذيد إلى الشارقة فكان الطريق يأخذ منه يومين، مشياً على الأقدام وأمامهم ماشيتهم التي ينوون بيعها ويصلون بعدها إلى منطقة تسمى (الصبخة أو أم لقرط) يتوزعون بعدها حسب وجهتهم منهم من يذهب إلى عجمان، وبعضهم إلى دبي، ومن أراد الشارقة استمر في المسار نفسه».
على خطى بن لندن
في 28 نوفمبر 2011، نظمت هيئة أبوظبي للثقافة والتراث (دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، حالياً) رحلة بعنوان «على خطى مبارك بن لندن» لمسافة 1500 كلم، ما بين صلالة بسلطنة عمان وحتى العاصمة أبوظبي، وجسدت الرحلة أشهر عبور صحراوي، ما زال مختزناً في ذاكرة الرحالة، وفي مسيرها قطع الرحالة البريطاني أدريان هايز ومرافقاه الإماراتيان سعيد راشد المسافري وغافان محمد الجابري، مسافة 750 كيلومتراً من رحلتهم التي تتبع خطى الرحالة الشهير ويلفريد ثيسيجر (مبارك بن لندن).
واستطاع الفريق الثلاثي منذ بداية الرحلة عبور العديد من التحديات الطبيعية، حيث عبروا الأودية بعد الفيضانات التي سببها مرور الإعصار المداري «كيلا» بالإضافة إلى العيش على كميات محدودة من الطعام بعد تجربة المرور عبر التضاريس الطبيعية المختلفة، كجبال ظفار ووادي مرحيت والوصول إلى مغشن، فيما قام عضوا الفريق الإماراتيان سعيد راشد المسافري، وغافان محمد الجابري بتقديم المشورة والمعلومات القيمة حول كيفية التعامل مع الجمال خلال فترة الرحلة لادريان هايز، والعديد من النصائح حول كيفية البقاء على قيد الحياة في الصحراء والتي يحتاجها الفريق لإتمام الرحلة، وعبّر أدريان هايز في تصريحات آنذاك عن سعادته بعدد الزوار الذين قاموا بزيارة المخيم والذين أرادوا معرفة معلومات أكثر عن رحلاتنا ومشاركتنا بقصصهم الرائعة حول الرحالة القديم مبارك بن لندن.
وأنجز فريق رحلة «على خطى مبارك بن لندن» رحلته على ظهور الجمال، ومشياً على الأقدام، لمسافة طويلة جداً، معتمدين على مواد المؤن الرئيسية، وطبيعة الضيافة والكرم البدوي لعربي المعهود، للبقاء على قيد الحياة وقدرة على مواجهة الصعاب ومرارة العيش، في رحلة شاقة امتدت لنحو 45 يوماً في الصحراء.
وانطلق الفريق من صلالة أواخر شهر أكتوبر من 2011، ووصل إلى مدينة ليوا في الدولة، مستكملاً رحلته بكل تفاصيلها القديمة إلى مدينة العين، ثم وصل بعدها إلى محطته الأخيرة في العاصمة أبوظبي في 12 ديسمبر من العام نفسه.
الآبار..استراحات «صحراوية»
كان الطوي «البئر» جزءاً مهماً من رحلات تنقل القوافل الإماراتية عبر الصحراء والطرق، حيث كانت جميع هذه الطرق الصحراوية تتمتع بوجود عدد من الطوايا، التي كانت تسهم بشكل قوي في مرور القوافل لنيل قسط من الراحة، ثم مواصلة المسير، ولعبت هذه الطوايا دوراً فاعلاً في تنشيط التجارة بين مختلف قرى وواحات ومدن الإمارات.
ويقول الباحث التراثي خليفة بن دلموك: «يعد الماء في المناطق الصحراوية ثروة ثمينة يجب احترامها وتقاسمها، فقد أعطى الإسلام الذي ظهر في قلب الصحراء قيمة رمزية كبيرة للماء، وكان الماء في الإمارات في مرحلة ما قبل اكتشاف النفط مسألة حياة بالنسبة للسكان».
ويضيف ابن دلموك: «كان استعمال وسائل تقليدية وبسيطة كافياً لجمع أي قطرة ماء، وسد احتياجات السكان، وبعد ذلك وبازدياد الطلب بدأ نقل الماء من أماكن بعيدة يتوافر فيها الماء إلى مناطق أقل حظاً، وظل هذا الوضع قائماً منذ عام 1964 حيث بدأت أعمال الطرق المرصوفة تربط قرى ومدن الإمارات، بعد أن كانت الطرق عبارة عن مدقات رملية عبر الصحراء والسبخات»، ويوضح أن «القوافل كانت لا تسير في الصحراء بالمسارب أو الممرات التي لا تكون فيها آبار وموارد للماء، وكانت بالنسبة لهم مهمة جداً لأنهم لا يستطيعون أن يستمروا في هذه الحياة من دون الماء، وكذلك من دون هذه الآبار ومن دون من يحفرها ويرعاها».
ويضيف: «ظلت الطرق التاريخية كما كانت منذ القديم؛ نظراً لأن الناس كانوا يتنقلون بالطرق المعروفة، لأن الحماية والدلالة والماء العذب والرعي للراحلة، متوافرة في هذه الطرق التي لم تتغير معالمها منذ أن كانت الرحلات في هذه المنطقة مع فجر التاريخ.. لكن التغيير الذي حدث كان طفيفاً عندما تطور السفر عن طريق السيارات، حيث أخذ الناس يبحثون عن الطريق الأقصر، ولو لم يكن به ماء».
ويقول: «قبيلة الطنيج اشتهرت بحفر الآبار، ويجيدون إصلاحها، ويعملون في حفر وإصلاح الآبار بشكل جماعي، ووالدي المرحوم عبيد بن سعيد بن دلموك، كان يتعاون مع زميل له اسمه نهيل محمد مصبح الحافري، في حفر وإصلاح الآبار مقابل أجر بسيط، واشتهرا بهذا العمل في منطقتي سهيلة والذيد وما جاورهما».
ويوضح الدكتور حمد بن صراي، أن أشهر طرق القوافل القديمة هي طرق الحجّ التي تخترق منطقة الإمارات من شرقها إلى غربها، يسير فيها الحجّاج في سبل منتظمة، يقودها رجال أدلّاء ذوو خبرة، ومهارة ودراية ودُربة، فكان الطريق يبدأ من كلباء على السّاحل الشرقي، وكان الركب يمر بالفجيرة فيلتحق به مَن يرغب في الحجّ، ثمّ يمرّ الركب بالقرى الواقعة في الطريق إلى أن يبلغوا قرية مسافي، ومنها باتّجاه قريتَي المنامة والسّيجي، ثمّ ينطلق الركب غاذّين السَّير صوب الذّيد، وتنتشر أخبار السائرين بين الأهالي في المناطق المجاورة، فينضمّ إليهم مَن أعدّ عدّته للحجّ فيلتحق بالركب النّفر والاثنان والجماعة، فيعبر الجمع الوديان والشِّعاب والسّيوح والسّهول حتى تتجمّع القوافل في منطقة مزيرع، على اعتبار أنّها مرتكز أو نقطة التقاء ومنها غرباً إلى الخوانيج في إمارة دبي، ثمّ إلى موضع ذباح القريب من جبل علي، ثمّ إلى موضع بوصلف قرب المفرق في إمارة أبوظبي، لتتّجه غرباً صوب موضع العجيلة، حيث تكثر آبار المياه، ثمّ تنطلق في خطّ مستقيم نسبيّاً إلى منطقة السلع وسبخة مطّي.
